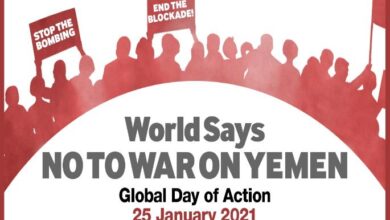الإمارات تدفع السعودية للتخلي عن حكومة هادي ودعم الانفصاليين

تدفع دولة الإمارات نظام آل سعود للتخلي عن حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رغم أنها الجهة الشرعية في البلاد التي يفترض أن التحالف السعودي تدخل عسكريا من أجل أن يساندها.
وعندما بدأت الانتفاضة في اليمن، التي أطاحت في نهاية المطاف بـ “علي عبدالله صالح”، كان “بن علي” في تونس قد سقط بالفعل، وكذلك “محمد حسني مبارك” في مصر، وكان حلف الشمال الأطلسي، (الناتو) قد بدأ تدخله في ليبيا للإطاحة بـ “القذافي”.
ووصل الإسلاميون إلى السلطة في كل هذه البلدان، حيث بدأ الرئيس الراحل “محمد مرسي” في مصر تقاربا محدودا مع خصم السعودية اللدود إيران.
وكانت المنطقة تتغير بوتيرة سريعة، وكانت موجة “الثورات” تتجه شرقا نحو الممالك الخليجية، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق والذعر في الرياض.
قبل نشوب انتفاضة اليمن، كان الربيع العربي يهدد المملكة من الغرب. وعندما نزل اليمنيون إلى شوارع صنعاء مطالبين بالإطاحة بحليف السعودية منذ فترة طويلة “علي عبدالله صالح”، بدأ التهديد يظهر على الحدود الجنوبية، ما ضاعف الشعور بالتهديد بين المسؤولين السعوديين.
وكان تفسير الرياض لمختلف ثورات الربيع العربي مختلفا وغير متماسك في كثير من الأحيان. وفي حين كان يُنظر إلى تونس على أنها ثورة شعبية، اعتقد المسؤولون السعوديون أن التغييرات في مصر كانت نتيجة “عاصفة كاملة” اجتمعت فيها مصالح الجيش المصري في رفض محاولة “مبارك” تمرير الرئاسة لابنه مع الحمى الثورية التي كانت تجتاح المنطقة.
وفي ليبيا، شعرت السعودية بالقلق من دعم الدوحة الشامل للحركات المناهضة للنظام، متهمة قطر باستخدام منافذها الإعلامية لتوجيه الغضب الشعبي إلى خصومها لتسهيل صعود الإخوان المسلمين كقوة إقليمية جديدة.
وفي محاولة لاحتواء انتشار الربيع العربي الناشئ على حدودها الجنوبية، شرعت المملكة في مبادرة تحت راية مجلس التعاون الخليجي من أجل انتقال تفاوضي للسلطة، يهدف بالأساس إلى تأمين حدود المملكة الجنوبية.
ومع ذلك، رفض الرئيس آنذاك “علي عبدالله صالح” المبادرة، ونما استياؤه بسبب رفض الرياض دعمه بشكل مطلق ضد المتظاهرين.
وبدأ المزاج السائد في المنطقة يتغير بينما كانت الاحتجاجات اليمنية لا تزال تتدفق. في البداية، أطاح “عبدالفتاح السيسي” بحكم “مرسي” في مصر، وهو ما أثار عاصفة في وجه الإخوان المسلمين في تونس، الذين وجدوا أنفسهم يواجهون احتجاجات من جهات داخل المجتمع سعت للاستفادة من زخم التطورات في مصر.
ونتيجة لذلك، تم تدشين حوار وطني تنازلت فيه حركة النهضة عن رئاسة الوزراء. وفي ليبيا، أصبح الإسلاميون في المؤتمر الوطني العام قلقين بشأن مستقبلهم في بيئة تتوافر فيها الأسلحة للجميع، وترتع فيها الميليشيات دون عقاب، خاصة في ظل تزايد الاستياء الشعبي.
ومع اقتراب انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام، بدأ الإسلاميون في استكشاف طرق أخرى لتمديدها وتجنب احتمال الانتخابات.
أما في اليمن، فقد ضغطت بقوة لإنفاذ مبادرتها الخليجية التي قبلها “صالح” في نهاية المطاف وسلم السلطة لنائبه “عبد ربه منصور هادي”.
وكان هناك حوار وطني لاحق شارك فيه الحوثييون أنفسهم، وجرى بموجبه تشكيل حكومة من شأنها الإشراف على الفترة الانتقالية قبل إجراء انتخابات واسعة على مستوى البلاد. وكانت الرياض راضية عن النتيجة.
ومع ذلك، بعد أقل من عام، دخل الحوثيون في تحالف مع الرئيس السابق “علي عبد الله صالح” للاستيلاء على صنعاء بالقوة، وهو ما دفع السعودية للتدخل عسكريا في اليمن لاستعادة حكومة هادي في عام 2015.
لكن الاختلافات سرعان ما بدأت تضرب التحالف السعودي، بعدما بدأت الإمارات، حليف السعودية الافتراضي في دعم الانفصاليين الجنوبيين في اليمن. وكان دعم أبوظبي المستمر للمجلس الانتقالي الجنوبي واضحا في أواخر عام 2019، عندما أرسلت طائراتها لقصف القوات الحكومية التي سعت لاستعادة عدن من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي لتسهيل عودة الرئيس “هادي”.
وأربك هذا المراقبين، حيث تم تفسيره على أنه ضربة للمملكة. ومع ذلك، حتى إذا كانت المملكة ملتزمة بشدة باستعادة حكومة “هادي”، فلا يمكنها ببساطة أن تنفصل عن حليفتها أو الوقوف ضد رغباتها.
وكانت الإمارات جزءا لا يتجزأ من الثورة المضادة، حيث بذلت كل جهد ضد حركة الربيع العربي التي كان يُنظر إليها على أنها تهديد وجودي للسعودية.
وتمتد المصالح السعودية المشتركة مع أبوظبي إلى ليبيا ومصر والسودان والعراق واحتواء تركيا. وكانت الدولتان شريكين ثابتين في جميع القضايا الإقليمية المثيرة للجدل تقريبا، ما يعني أن كلمة أبوظبي تفوق كلمة “هادي” وحكومته، وأن الرياض ستكون أكثر ميلا إلى التنازل أمام أبوظبي نظرا للتوافق الواسع في المصالح بينها. بحسب موقع “إنسايد أرابيا”.
بخلاف ذلك، يُعتقد أن ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” لعب دورا شخصيا ومباشرا في تسهيل صعود ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، والضغط من أجل اعتراف واشنطن به.
وقد تكون المملكة منزعجة من الحرج العام الناجم عن تصرفات أبوظبي. لكن الافتقار إلى بدائل ذات مصداقية تتوافق مع المصالح السعودية يعني أن العمل مع الإمارات يبقى الخيار “الأفضل”.
لكن سرعان ما أصبحت المملكة منهكة بسبب الأضرار التي لحقت بسمتها والانتقادات الواسعة لدورها في اليمن. وبالرغم من حقيقة أن الحوثيين أطاحوا بحكومة اتفقت عليها جميع الأحزاب السياسية اليمنية، وأغرقوا البلاد في الحرب، تركز التغطية الإعلامية على الأزمة الإنسانية الناجمة عن حملة المملكة العسكرية الكارثية التي فشلت في تحقيق تقدم كبير في تحقيق هدفها الأساسي وهو إبعاد الحوثيين عن صنعاء.
ومن وجهة نظر الرياض، لم تكن اليمن أبدا حربا أرادت الدخول فيها طواعية. وكان “بن سلمان” يدرك العواقب الوخيمة لحملة ابن عمه الأمير “خالد بن سلطان” ضد الحوثيين عام 2009 عندما كان والد الأخير وليا للعهد، وكان “خالد” يُنظر إليه كملك محتمل في المستقبل. لكن الحملة الفاشلة أنهت كل آمال الأمير “خالد”.
علاوة على ذلك، لم يكن “بن سلمان” آمنا في الداخل في بداية الحرب في اليمن، وكان لا يزال متورطا في صراع شرس مع المنافسين الأقوياء مثل “محمد بن نايف”.
وكان الهدف في اليمن دائما هو احتواء إيران، التي يُنظر إليها على أنها تسيطر بشدة على بغداد على الحدود الشمالية للسعودية، وتمارس القوة في الخليج العربي في الشرق، وتدعم الحوثيين على الحدود الجنوبية حيث تطلق الميليشيات الصواريخ على البر السعودي.
لكن تدخل المملكة في اليمن تسبب في النهاية في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للبلاد، وساهم في انتشار المجاعة والكوليرا وتفاقم الأزمة الإنسانية بسبب استمرار الحرب وغياب أي أفق للسلام.
ونتيجة للأزمة الإنسانية المتصاعدة، التي لا تظهر أي بادرة على التراجع، تبدو الأمم المتحدة أكثر اهتماما بالسلام بأي ثمن بدلا من الوصول إلى اتفاق جاد بين جميع الأطراف اليمنية.
وشعرت السعودية بالإحباط بشكل خاص من تدخلات الأمم المتحدة التي ترى أنها أنقذت الحوثيين من هزيمة عسكرية.
وفي عام 2018، هاجم التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والقوات الحكومية اليمنية مدينة الحُديدة الساحلية الحيوية في محاولة لقطع خطوط إمداد الحوثيين.
وفي محاولة أخيرة، اتصل الحوثيون بمبعوث الأمم المتحدة قائلين إنهم على استعداد للتحدث. وطالبت الأمم المتحدة بسرعة بإنهاء الهجوم واستقبلت الأطراف المختلفة في ستوكهولم. حيث وقع الحوثيون الاتفاق، وعززوا مواقعهم، ودعموا خطوط إمدادهم، ثم تراجعوا. وعند هذه النقطة كان الهجوم السعودي قد فقد الزخم.
في الوقت نفسه، بدأ الحوثيون في إظهار قدرتهم على استهداف العمق السعودي، وهو ما جعل المملكة مقتنعة بأهمية إنهاء الحرب بأي ثمن، حتى ولو لم تحقق المملكة هدفها الأساسي المتمثل في إزاحة الحوثيين.
وإذا حدث ذلك، فإن حكومة هادي ستكون في حالة يرثى لها بعد فشلها في عكس الانقلاب، وسيصبح الحوار الوطني فكرة بالية.
وفي مثل هذه الحالة، يمكن أن يكون التحالف مع المجلس الانتقالي الجنوبي مفيدا في الحد من التأثير الجديد للحوثيين في تحديد مستقبل اليمن.
ويدرك المسؤولون السعوديون أن “ترامب” يعاني في استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، وأن هناك احتمالا أن يفوز “بايدن” في الانتخابات.
ويُعتقد أن الديمقراطيين سيكونون أكثر حدة في سياساتهم تجاه نظام آل سعود وأنهم أكثر تعاطفا مع إيران.
وبالنظر إلى أن الحوثيين مدعومون من إيران، لا يمكن للرياض أن تضمن أن موقف الولايات المتحدة سيكون داعما لمحاولتها استعادة الحكومة المعترف بها دوليا، وقد تجد نفسها تواجه أصواتا حريصة على معاقبة “بن سلمان” على استخدام النفط كسلاح ضد واشنطن، فضلا عن قتل الصحفي “جمال خاشقجي” والانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى لحقوق الإنسان.
لذلك، للاستعداد لمثل هذا الاحتمال، قد تعتقد المملكة أن دعم المجلس الانتقالي الجنوبي قد يكون مفيدا في حال انتهت الحرب بمأزق بين الشمال والجنوب.
وبالرغم من هذه الاعتبارات، فإن خطاب هادي من الرياض، في 27 يونيو/حزيران، الذي يدين استيلاء المجلس الانتقالي على جزيرة سقطرى، يشير إلى أن المملكة ملتزمة بالحفاظ على نتائج اتفاق الرياض والوساطة بين “هادي” وقيادة المجلس.
ويعد السيناريو المثالي لنظام آل سعود هو استعادة الحكومة المعترف بها دوليا وطرد الحوثيين من صنعاء. وبهذه الطريقة، يمكنها الحفاظ على نفوذها والتدخل عند الضرورة لمنع أي تهديد محتمل.
ومع ذلك، مع تزايد حدة الانقسامات في اليمن، وتراجع ثقة المجتمع الدولي في “شرعية” حكومة “هادي”، وتركيزه على احتواء الأزمة الإنسانية، قد تجد المملكة أن الرهان على المجلس الانتقالي الجنوبي هو الخيار الأضمن للحفاظ على بعض السيطرة على الأمور في اليمن، بدلا من الإصرار على استعادة حكومة “هادي” بالقوة، وهو الخيار الذي ثبت فشله على مدار أكثر من 5 أعوام.