مشايخ في خدمة توجهات محمد بن سلمان
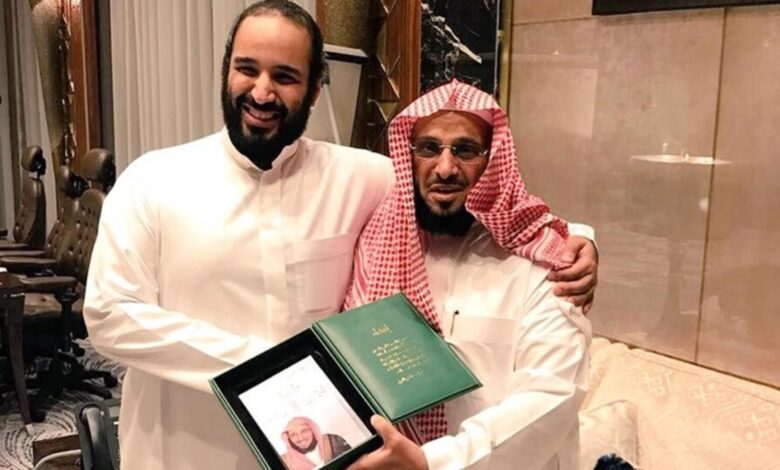
انتشر في الأيام الماضية تسجيلان مرئيان، أحدهما للشيخ عائض القرني يشن فيه هجومًا من المملكة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويتبرأ فيه من ثنائه السابق عليه؛ بحجة أنه انخدع به سابقًا، ويعترف على نفسه وزملائه بالسذاجة، ولذلك يقوم هنا بواجب التبيين للمخدوعين ممن لا يزالون على مثل حالته السابقة. والثاني للشيخ صلاح الدين إبراهيم من فلسطين وفيه يسوغ تأييده لرئيس النظام السوري بشار الأسد معتبرًا أن موقفه هو موقف الله ورسوله!
ورغم أن “سردية” كل فيديو والغرض منه تختلف عن الآخر، فإنهما يتمحوران حول فكرة واحدة طالما أثارت الجدل، وهي “طاعة ولاة الأمر”. فإبراهيم ينافح بشدة عن فريضة طاعة ولي الأمر التي هي مثل فريضة الصلاة، والقرني ينهض بواجب الطاعة لولي الأمر التي لا تقبل المساومة عنده بل إن ولي أمره هو زعيم المسلمين.
أي أن كلا الرجلين يعلق في تسجيله المصور على وقائع سياسية محددة، ويذكر بالاسم قيادات سياسية محددة: رئيس تركيا، ورئيس النظام السوري، وملك السعودية وولي عهده؛ ومع ذلك يزعم كل منهما أنه إنما يتحدث في شأن ديني بحت!
ولأن المحتوى السياسي في فيديو القرني فاقعٌ ويفتقر إلى أي مضمون ديني، رغم حَشْره لمسائل (الشركيات والبدع وعقيدة وحدة الوجود) في خطاب سياسي لا صلة له لا بعلم الكلام ولا بمفهوم الإيمان؛ إذ الغرض المعلن من الفيديو هو نزع زعامة تركيَّة مُفتَرضَة للعالم الإسلامي من أجل تأكيد زعامة سعودية مفترضة للعالم الإسلامي تحت القيادة الحالية للملك سلمان وابنه، وكذلك تثبيت صفة “الإسلامية” على السعودية ونزعها عن تركيا.
ذلك لأن القرني ومَن وراءه يتصورون أنه بذلك يمكن استخدام سلاح الدين في خصومة سياسية بين تركيا والسعودية، كما يمكن استعادة بعض الوقائع التاريخية أيضًا لخدمة الغرض نفسه، ومن هنا نص في الفيديو على أن الخلافة العثمانية احتلال، في استعادة صريحة لوقائع وأجواء الصراع بين العثمانيين والوهابيين.
أما إبراهيم -الذي يظهر متحدثًا من داخل المسجد الأقصى- فإنه يُلحّ على حُجة مركزية، وهي أن السلطة إنما هي لله ورسوله وحدَهما دون غيرهما حتى ولو كان ابن تيمية نفسه، والمعبِّر عن هذه السلطة هو نصوص القرآن والحديث (قال الله وقال رسول الله)، فلا مجال لأي رأي هنا.
بل إن الأوامر نفسها تتساوى عنده، فالأمر النبوي بطاعة ولي الأمر كالأمر بالحج والطواف وتحديد عدد ركعات الصلاة سواءً بسواء، وفي كل هذه الأوامر نحن لا ندري مرادها ولا نسأل فيها: (لِمَ؟)، ولكن نمتثل فقط فنسمع ونطيع؛ لأن الله أمر بذلك.
وبناء عليه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نطيع ولاتنا ولم يحدد لنا صفة محددة في الولي الذي تجب طاعته، ولا ناقشَ كيف جاؤوا إلى السلطة، بل إن اشتراط كونهم “ولاة شرعيين” هو من تعبير العامة!
يكشف إبراهيم هنا عن رؤية حرفية (وليست حتى نصية) في فهم الأوامر والنواهي الإلهية، ويرتكب أربعة اختزالات: الأول: أنه يجهل العلاقة بين الدين والسياسة، وأن قوله وفعله هذا هو فعلٌ سياسيٌّ بامتياز؛ لأنه بعمله هذا ينحاز إلى نظام بل نُظم (فهو يساند الأسد ومعمر القذافي)؛ بحجة الامتثال لأمر الله ورسوله، رغم عدم وجود أي (نص خاص) يتحدث عما يجري في ليبيا وسوريا، فهو إنما يستند إلى عمومات تحتمل تأويلات عدة.
الثاني: أنه يختزل المرجعية في النص وحده، ومن ثم فهو يُقصي إرثًا تاريخيًّا ضخمًا نشأ من حول هذه النصوص: توثيقًا وفهمًا وتأويلاً، وتنظيرًا وممارسةً، أي أن النص الصافي لم يوجَد وحده من دون فعل بشري تأويلي تعاقبت عليه أجيال، واندمج في التاريخ، فلا وجود لنص خالص؛ لأن النص منغمس في التاريخ منذ لحظة قوله إلى لحظة نقله فتوثيقه فتأويله وتطبيقه؛ فالنص بقي باستمرار ملتحمًا بالجماعة المسلمة على تنوع فهومها وتراكم منهجياتها في تحديد “مراد الله” تعالى من هذا النص أو ذاك.
الثالث: أنه يختزل المراد الإلهي في لفظ الأمر والنهي، فلا مجال للحديث هنا عن قيم ومفاهيم أخلاقية كلية كالعدل والظلم والبغي، والمعروف المنكر، وغيرها من المفاهيم الكلية التي هي من صميم الدين، بل من صميم الإرادة الإلهية التشريعية.
ولقد أدرك أئمة الإسلام عبر التاريخ تركيبية الأمر والنهي، وبحثوا في سعة الإرادة الإلهية التشريعية المتمثلة في (الأمر والنهي) بالمعنى الواسع، والإرادة التكوينية المتمثلة في الفعل الإلهي القدَري، ليَحلّوا مشكلة العلاقة بين التكليف والقدَر، وأن فعل العبد لا يتناقض مع إرادة الله القدرية، ولكنه يمكن أن يتناقض مع إرادة الله التشريعية حين يفعل العبد ما لا يأمر به الله تعالى.
ميّز العلماء السابقون أيضًا في الأوامر بين ما هو معقول المعنى وما هو تعبدي محض، إما أنه لا يُعقل معناه أو أننا نحن لم نعقل معناه، كما أنهم أدركوا أن الأوامر تتنوع وأن بعضها مطلق، وبعضها مقيدٌ بشخص أو مجموعة أو سياقٍ محدد، فيكون تعميمه أو تنزيله على غير سياقه مخالفةً لمراد الله تعالى، فالأوامر المعقولة المعنى معلَّلة لا تُطبق إلا عند وجود علتها التي إنما وُجد الأمر لأجلها.
الرابع: يفترض إبراهيم أن فهمه هو مراد الله تعالى، وأي مخالفة لما فهمه هو فهي مخالفة لمراد الله، أي أن مراد الله لا يقع إلا على وَفْق مراد إبراهيم، رغم أن ثمة مسافة تفصل بين قول الله ورسوله من جهة، وأفهام الناس ثم تطبيقاتهم للأوامر والنواهي من جهة أخرى؛ فثمة حكم عام أو كلي، وهو أمر الله تعالى ورسوله المجرد عن الأزمان والأشخاص، وثمة حكم خاص وجزئي يتمثل في “أحكام المعيَّنات” التي لا تقتصر على النص فقط بل يدخل فيها اجتهاد الأفراد والرأي أيضًا.
فحين نحول الأمر العام أو الكلي إلى تطبيق فعلي محدد خاص بزمان وشخص محدَّدَيْن فنحن نقوم بعملية تأويل، وهو الذي يسميه الفقهاء “تحقيق المناط”؛ لأن ثمة دائمًا مسافة تفصل بين الحكم الكلي من جهة وتطبيقاته من جهة أخرى.
فالحكم الكلي يبقى كليًّا؛ لأنه يعبر عن شكل نموذجي، أو عن الحد الأقصى الذي يجب أن تتم المقايسة أو المعايَرَة عليه. أما الحكم الجزئي فيخضع لإكراهات السياق، وللإمكانات المتاحة للأفراد في تطبيقه، ولطبيعة فهمهم له أيضًا، وكل هذه مسائل نسبية تتنوع وتختلف. وفي المحصلة؛ فإن المسؤولية الأخلاقية فردية وتترتب -عند الله تعالى- بحسب فهم وممارسة كل شخص للأمر الكلي أو العام، وبحسب مبلغ علمه واستفراغه وُسعَه في البحث عن مراد الله منه في الواقعة المعينة.
وحين يأتي صلاح الدين إبراهيم ويتخيل أن أمر النبي بطاعة ولي الأمر هو أمر تعبديٌّ غير معقول المعنى، وأنه أمرٌ بطاعة بشار الأسد ومعمر القذافي على التعيين، فهو يقوم بعملية تأويل محض؛ لأن الأمر النبوي أمرٌ عامٌّ ويحتمل احتمالات عدة: أن يبقى الأمر على عمومه فتكون الطاعة مطلقةً حتى ولو أمروا بمعصية لله، ومن ثم سيتعارض مع أوامر أخرى منها الموازنة بين أمر الله وأمر ولي الأمر؛ فأمر الله هو مصدر الأمر بطاعة ولي الأمر ولا يمكن أن يلغي الفرعُ الأصلَ الذي انبنى عليه، ومنها أمر الله بإقامة العدل ونهيه عن الظلم، وأمر الرسول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتغييره باليد.
ومنها أيضًا الأحاديث التي تعارض حديث السمع والطاعة، كالحديث الذي رواه البخاري ومسلم: “يُهلِك الناسَ هذا الحيُّ من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم”، وقد رأى الإمام أحمد بن حنبل أن حديث اعتزال ولاة الأمر معارِضٌ لحديث السمع والطاعة؛ ومنها الحديث الذي رواه مسلم: “فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل”.
أي أن الوضوح والوثوقية التي يصورها إبراهيم هي صورة ساذجة، فضلاً عن أن دلالة العموم على جميع مشمولاته ظنية، فالأمر بطاعة ولي الأمر أمرٌ عامٌّ يفيد دلالة ظنية وفق قواعد جمهور الأصوليين، ومن ثم فلا وجود للمعني الحرفي القطعي الذي علينا الامتثال له كما يتوهم إبراهيم، ومن ثم فإن الرأي يَحفّ بالنص وفهمه منذ لحظة تلقيه ونقله إلى توثيقه فتأويله ثم الامتثال له، وذلك بحسب ما نفهم منه نحن!
إن شطب مساحة الرأي كليةً بحجة وجود نصٍّ خالص ومعنى حرفيٍّ واحد وموضوعي، تغيب فيه ذات المؤول والمتحدث ليكون اللهُ ورسوله فقط هما اللذان ينطقان على لسانه هو: وَهْمٌ لا وجود له في مثل هذه الحالة؛ كما أن الحجة التي يستخدمها إبراهيم لتسويغ الأوامر الإلهية وهي أنها تستوجب الامتثال لمجرد كونها “صادرة عن الله”، هي حجة استخدمها كثيرًا اللاهوتيون البروتستانت ويستخدمها عامة السلفيين المعاصرين، وتعكر عليها الإشكالات السابقة التي أوردناها من جهة.
كما تعكر عليها حقيقة أن النصوص المعبِّرة عن إرادة الله محدودة أيضًا؛ فماذا نفعل في غياب النص؟ بل حتى مع وجود النص فإن الإرادة الإلهية التشريعية قد تخفى، وقد تختلف النصوص وتتناقض فتغمُض إرادة الله، وفي كل هذه الحالات نحن بحاجة إلى استعمال الرأي لاستنباط منهج متماسك للتأويل يساعدنا على الكشف عن الإرادة الإلهية، وهو ما قام به العلماء عبر التاريخ.
ثم إن مصطلح “الفتنة” الذي كثيرًا ما يُستخدم هنا متشعبُ المعاني، ولكنه -في دلالته السياسية- يُراد به الانقسام والاقتتال الداخلي والاضطراب السياسي وغيره، وقد جرى شراح الحديث على أن المراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يُعلَم المحق من المبطل، دون المعنى العام والسائل الذي يتم توظيفه فيه من قبل مفتي الأنظمة الاستبدادية.
وقد شكّل الثوَرَان في طلب الإمامة والاختلافُ على الإمام وسياساته مادةً أساسية للفتنة والتفرّق في كتب التاريخ، ثم انضمت إلى ذلك -مع تطور الدولة وامتداد الحكم- سياساتُ الحكام وخلافات الأسَر الحاكمة وشغَب الجند والنزاع بين الدويلات التابعة للخلافة، ليتحول مصطلح “الفتنة” في الأزمنة المتأخرة إلى رافد أساسيّ لفكرة الطاعة السياسية، وأن معارضة السلطة أو الخروج عليها هو أساس الفتن ومبدؤها، لا فعل السلطة نفسها وعسفها وظلمها، ولا حتى بالشراكة معها!
القضية المركزية التي يتجاهلها من يحوِّلون “طاعة ولي الأمر” إلى عقيدة دينية، هي أن الخروج على الإمام الجائر كان مذهبًا لعدد من الصحابة ومَن بعدهم من الفقهاء في القرون الثلاثة الهجرية الأولى، ولذلك جاء ابن حجر العسقلاني فقال: “وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على تَرْك ذلك؛ لمّا رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه؛ ففي وَقعة الحَرَّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظَة لمن تَدَبر”، أي أن مسألة الخروج -ويعنون به هنا حصرًا الخروج المسلح لإزالة الحاكم الجائر- مسألة معقولة المعنى وتحتمل النقاش والتأويلات.
وقد اتفق الفقهاء على تحريم القتال مع أئمة الجور ضد مَن خرج عليهم من أهل الحق، ومِن القتال معهم إعانتهم بكل صغيرة وكبيرة، وهو مصداق قوله تعالى: (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ).
وإذا كان هذا في الخروج المسلح؛ فإن الأمر يختلف في حالة الدفاع عن النفس التي فرضتها تطورات الوضع السياسي وتعقيداته كما حصل في سوريا وليبيا، بعيدًا عن الفهم المغلوط الذي يتنباه إبراهيم وغيره لما جرى في الواقع. هذا فضلاً عن أن مفهوم الطاعة لا يستقيم مع مفهوم الدولة الوطنية التي نعيش فيها؛ لأن الطاعة جزء من منظومة كلاسيكية مترابطة لم يكن فيها “مجال سياسي”، ولا انتخابات وبرلمانات وقوانين حديثة ومنظومة دولية وغير ذلك، وكل هذا يقتضي تغيرات في الفهم وتنزيل الكلي على الجزئي؛ والله أعلم.





