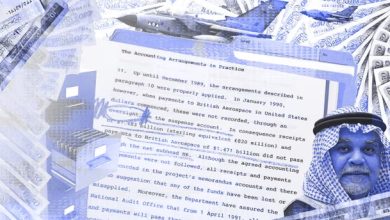تداعيات جائحة كورونا تهدد استقرار نظام آل سعود

من المرجح أن التداعيات والسياسات لجائحة فيروس كورونا ستكلف خزائن المملكة مليارات الدولارات سواء من الخسائر المتوقعة في أسعار النفط أو تكاليف الإغلاق الاقتصادي.
غير أن مراقبين يعتبرون أن هذه التكاليف تبقى هيّنة بالمقارنة مع التداعيات الجيوسياسية طويلة المدى التي سيُخلِّفها تفشي الوباء على مستوى الاقتصاد والسياسة والمجتمع في المملكة.
إذ يبدو أن فيروس كورونا جاء ليُسرِّع من وتيرة ديناميات كانت تعمل بالفعل منذ عدة سنوات في غير صالح الرياض، وعلى رأسها فقدان المملكة لقيادة أسواق النفط، وتراجع مكانتها في العالم الإسلامي، وانكفاؤها المحتمل على ذاتها لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتوترات الداخلية.
وعليه سيكتشف ولي العهد محمد بن سلمان، سريعا مع وصوله إلى السلطة أنه سيحكم دولة مختلفة تماما عن تلك التي حكمها أسلافه على مدار العقود السابقة.
إذ حتى قبل أزمة كورونا، لم يكن أداء أسواق النفط مُرضيا بالنسبة للمملكة بشكل كبير، حيث لم تكن مستويات الأسعار التي تتأرجح بين 60 و70 دولارا للبرميل كافية لجلب التعادل للموازنة السعودية التي تحتاج إلى مستويات أسعار تتراوح حول 90 دولارا، وقد تسبّبت هذه الأسعار المنخفضة نسبيا في تراجع أرباح شركة النفط الوطنية “أرامكو” بنسبة 20% في عام 2019 لتُحقِّق 88 مليار دولار فقط من الأرباح مقارنة بـ 111 مليار دولار في عام 2018 رغم طرح 1.5% من أسهمها في البورصة خلال هذا العام.
ومع زيادة المخاوف حول عدم استدامة الأسعار والتأثير المحتمل للأسعار المنخفضة على ربحية أرامكو وأسعار أسهمها، وكذلك على حجم الأموال المتوفرة لتمويل رؤية التحول الاقتصادي لبن سلمان، بدأت المملكة في الضغط على الدول المنتجة من أجل إجراء تخفيضات أكبر في الإنتاج ضمن تحالف “أوبك بلس” الذي يُدير أسواق النفط بشكل فعلي منذ عام 2016.
لكن روسيا رفضت الانصياع للضغوط السعودية لإجراء تخفيضات إضافية في إنتاج النفط، مع كون الاقتصاد الروسي يمتلك أريحية أكبر في التعامل مع مستويات سعرية منخفضة ربما تصل إلى 40 دولارا، ومع مخاوف موسكو من فقدان حصتها السوقية لصالح منتجي النفط الصخري الأميركيين حال وافقت على تخفيضات إضافية في الإنتاج.
موقفٌ رد عليه نظام آل سعود بشن حرب أسعار مفاجئة وقصيرة النظر للغاية، أعلنت المملكة خلالها زيادة إنتاجها من النفط إلى 12 مليون برميل يوميا وتخفيض أسعار النفط للأسواق في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
ولكن في ظل تزامن حرب الأسعار السعودية مع انهيار تاريخي في الطلب على النفط بسبب التباطؤ في الاقتصاد العالمي بفعل تفشي فيروس كورونا، كانت النتيجة النهائية هي انخفاض الأسعار بشكل غير مسبوق إلى مستوى دون 20 دولارا للبرميل، وهو ما وضع النظام النفطي القائم على حافة الانهيار.
في نهاية المطاف، كانت الولايات المتحدة مضطرة للتدخل من أجل تنظيف الفوضى التي خلّفتها حرب الأسعار السعودية وإنقاذ ما تبقى من منتجي النفط الأميركيين من الإفلاس وتنسيق خفض تاريخي لإنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا، أي بما يعادل 10% من الإنتاج اليومي العالمي على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ مع مطلع مايو/أيار الحالي.
لكن استقبال الأسواق لأنباء التخفيضات الجديدة في الإنتاج كان فاترا على ما يبدو، مع كون جميع أماكن التخزين في العالم قد صارت مكدّسة بالنفط الرخيص ناهيك بمئات السفن التي تجوب البحر مُحمّلة بالنفط بحثا عن مشترين، ناهيك بالتوقعات القاتمة لانخفاض الطلب على النفط بمعدل يعادل ثلث الطلب العالمي (نحو 35 مليون برميل يوميا) بسبب تداعيات كورونا، ونتيجة لذلك فإن أسعار النفط حقّقت انتعاشا محدودا للغاية بعد الاتفاق (تم تداول خام برنت حول مستوى 30 دولارا) قبل أن تنهار مجددا إلى مستوياتها السابقة، مع توقعات بانهيار أكبر في الأسعار حال استمر إغلاق الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة.
يخلق هذا الانهيار الحاد والهيكلي في أسعار النفط معضلات اقتصادية وجيوسياسية، خاصة لدى الدول المنتجة للنفط وبخاصة المملكة.
ورغم أن المملكة تراهن دوما على قدرتها على استخدام احتياطاتها المالية الضخمة ومحفظتها من الأصول من أجل تمويل عجز الموازنة الناتج عن انهيار أسعار البترول كما فعلت من قبل خلال الأزمات السعرية السابقة، فإن المملكة لم تواجه من قبل انخفاضا مفاجئا في الأسعار على هذا القدر من الحِدّة، مع توقعات أن يستمر لفترة طويلة (ربما لمدة عام كامل وفق التقديرات المتفائلة).
أضف إلى ذلك أن جميع جهود تعزيز الطلب على النفط خلال البيئة الحالية سوف تكون مستحيلة تقريبا في ظل ركود جميع القطاعات المعتمدة على الوقود، وهو ما دفع المملكة لإعلان نيتها إجراء تخفيضات بنسبة 5% على ميزانية عام 2020 (بواقع 50 مليار ريال أو 13.2 مليار دولار)، وهو رقم كبير نسبيا بالنظر إلى أن معظم دول العالم تجد نفسها اليوم مضطرة لزيادة إنفاقها والاستثمار في حزم التحفيز المالي لمواجهة الركود الاقتصادي الناجم عن تفشي كورونا.
بخلاف ذلك، ومع استمرار تراجع الأسعار لفترة أطول، سوف تجد السعودية نفسها مضطرة لسحب الأموال من صناديقها السيادية بمعدلات أعلى مما كانت تنويه في الأصل، وهي الأموال التي كان يُفترض أن توجّهها المملكة لدعم أهدافها السياسية طويلة المدى مثل خطط التنويع الاقتصادي وتدخلها العسكري في اليمن ومواجهتها الأوسع مع إيران.
وتُشير التقديرات المتفائلة إلى أنه حتى مع الخفض الحالي في الإنفاق، فإن المملكة ستواجه عجزا في الموازنة مقداره 61 مليار دولار، وهو ما قد يُجبرها على تقليص حضورها في مسارح الصراعات خارج الحدود وتقليص الدعم لحلفائها الإقليميين من أجل توفير الأموال لإنقاذ الاقتصاد المتداعي.
لا تقف قائمة التداعيات السلبية عند هذا الحد، ففي حين أن أسهم أرامكو يتم تداولها اليوم داخل البورصة المحلية، في الوقت الذي يمتلك فيه 20% تقريبا من سكان البلاد حصصا متفاوتة من أسهم الشركة، فإن مسألة انخفاض أسعار النفط ستصبح أكثر حساسية من ناحية السياسة الداخلية، نظرا لأن انخفاض الأسعار يعني بالتبعية انخفاضا في قيمة الأسهم التي يتم تداولها اليوم عند مستويات سعرية أقل من أسعار الشراء، وهو ما قد يؤدي إلى غضب واسع بين مالكي الأسهم ربما يتحوّل إلى شكل من أشكال المعارضة التي قد تتفاقم بشكل خاص حال ظهرت بوادر الركود في البلاد، خاصة أن معدلات البطالة في المملكة بلغت نحو 12% نهاية عام 2019.
لكن لا شيء مما ستخسره المملكة ماليا يمكن أن يعادل التداعيات الجيوسياسية بعيدة المدى لنزيف المملكة للمزيد من نفوذها المتآكل في سوق النفط، وهو اتجاه بدأ منذ أزمة الأسعار السابقة في عام 2014 التي وقعت نتيجة تخمة المعروض العالمي وحملة السعودية لتقويض منتجي النفط الصخري الأميركيين.
ورغم أن المملكة ومنتجي النفط نجحوا -جزئيا- في ضبط الأسواق مجددا في عام 2016، فإن ذلك الانضباط جاء بثمن جيوسياسي باهظ، حيث كانت الرياض مضطرة للاعتراف أنه لم يعد بمقدورها التحكم في أسعار النفط بمفردها تحت لواء “أوبك”، وهو ما مهّد الطريق لظهور نظام نفطي جديد تحت اسم “أوبك بلس” بعد أن اتفقت الدول الأعضاء في أوبك مع 11 دولة خارج المنظمة لخفض الإنتاج بشكل مشترك من أجل جلب الاستقرار للأسواق الهابطة، وفي جوهره، كان اتفاق أوبك بلس تنازلا من السعودية عن سيادتها المنفردة على أسواق النفط واعترافها بروسيا كقوة مُهيمنة لا غنى عنها في أسواق الطاقة.
ويبدو أن هذه الدينامية تتكرر مجددا بالشكل نفسه تقريبا، حيث تجد السعودية وروسيا نفسيهما عاجزتين عن الوصول لطريقة لإدارة السوق تُلبّي مصالح كل منهما وهو ما يمهّد الطريق لدخول الولايات المتحدة كقوة ثالثة مُهيمنة لإدارة المعترك النفطي عبر رعايتها لاتفاق خفض الإنتاج الأخير، الذي ربما لن يكون فعّالا ما لم تُقرِّر واشنطن المشاركة بقوة في خفض الإنتاج هي الأخرى، حيث لن يكون اتفاق السعودية وروسيا وحدهما كافيا هذه المرة لجلب الاستقرار إلى الأسعار.
لا تكمن مشكلة السعودية الرئيسية إذن في خسارة بعض الإيرادات، فالمملكة لا تزال تستطيع التعامل مع هذا الأمر لبعض الوقت، وإن كان مع الكثير من الألم، لكن المشكلة أن مملكة محمد بن سلمان تجد نفسها اليوم مضطرة للتراجع خطوة للوراء مجددا والقبول باشتراك الولايات المتحدة في إدارة سوق النفط بعد أربعة أعوام فقط من قبول تشارك القيادة مع روسيا، ويُعَدُّ هذا تراجعا هائلا في النفوذ عند مقارنته بالمشهد الذي رآه العالم عام 1973 حين اصطفّت السيارات في الغرب في انتظار البنزين المستخرج من النفط السعودي. إلا أن الحال الآن بات مختلفا مع كون النفط يُباع اليوم بثمن قريب من سعر المياه المعدنية، وهو أمر لا تستطيع المملكة وحدها فعل شيء لتغييره على ما يبدو.
تخلق هذه الديناميات المتغيرة معضلة جوهرية لدولة ابن سلمان الجديدة، فطالما كان النفط هو مصدر نفوذ السعودية على الساحة الجيوسياسية، وهو الذي وفّر للرياض مقعدا على طاولة القوة الكبرى ومنحها عضوية مجموعة العشرين وملأ خزائنها بالأموال التي مكّنتها من مداعبة خيالات مورّدي الأسلحة في الدول الكبرى، وشراء ولاءات السياسيين وتوظيف جماعات الضغط والنفوذ، والحفاظ على علاقتها مع حليفها الأهم، الولايات المتحدة.
ولكن مع تراجع الأهمية الدولية للنفط السعودي وانخفاض عائداته في وقت تتعرض فيه سياسة السعودية لقدر غير مسبوق من التدقيق في الغرب بسبب الممارسات السياسية الجائرة للقيادة السعودية الحالية، من المُرجَّح أن المملكة سوف تواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على موقعها الحالي داخل النظام الدولي خلال السنوات المقبلة.
لا تقف تداعيات تفشي فيروس كورونا عند ذلك الحد، حيث يبدو أن تداعيات الوباء العالمي ستواصل النيل من المملكة على أكثر من صعيد، فمع توسُّع الرياض في سياسات الإغلاق لحماية نفسها ومواطنيها من الآثار الصحية لتفشي الوباء، فإنها تخاطر بتدمير السياحة الدينية، ثاني أهم مصادر الإيرادات في البلاد بعد النفط، وقد بدأت آثار هذا الإغلاق في الظهور بالفعل مع إلغاء موسم العمرة في المملكة في أشهر رجب وشعبان ورمضان (مارس/آذار – مايو/أيار 2020)، وتقييد إصدار التأشيرات السياحية إلى المملكة بفعل تفشي فيروس كورونا.
غير أن الأسوأ بالنسبة للمملكة على هذا الصعيد لم يأتِ بعد، فمع إعلان وزارة الشؤون الدينية في المملكة تأجيل إصدار تأشيرات الحج ومناشدتها الدول الإسلامية تعطيل إجراءاتها على هذا الصعيد، يتوقّع الجميع أن الأمر ليس أكثر من مسألة وقت قبل أن يتم إلغاء موسم الحج الذي يستضيف أكثر من مليوني شخص من مختلف أرجاء العالم الإسلامي في كل عام، ويدرّ أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة.
لكن مجددا، فإن أقل خسائر المملكة المتوقّعة جراء إلغاء موسم الحج هي مليارات الدولارات التي سيفقدها الاقتصاد السعودي جراء تعطيل المناسك المقدسة، ناهيك بمليارات أخرى من الدعم الحكومي التي سيتم ضخها لتعويض خسارة القطاعات المتضرّرة بسبب إجراءات الإغلاق مثل شركات الطيران والفنادق ومكاتب السياحة والبنوك.
وستظل الخسارة الأكبر للمملكة نتيجة لإلغاء موسم الحج، رغم كونها أقل قابلية للقياس مقارنة بالخسائر الاقتصادية المباشرة، هي ذلك الضرر البالغ الذي سيُصيب مكانة البلاد الرمزية وشرعيتها الدينية كقائد للعالم الإسلامي مع تداول الصور الخاوية للحرمين الشريفين ومواقع المناسك خلال موسم الشعائر المقدسة.
لطالما كانت الشرعية الدينية إحدى الدعائم الرئيسية التي قامت عليها المملكة العربية السعودية الحديثة منذ عهد الملك فيصل (1964-1975)، الذي أسّس السياسة الخارجية للمملكة على مبدأ الريادة الإسلامية مستغلا استضافة المملكة للحرمين الشريفين لإكساب بلاده سلطة دينية رمزية، وموظفا عائدات النفط لتدعيم هذه السلطة الأيديولوجية بالقوة المالية اللازمة لإنشاء المؤسسات ورعاية رجال الدين الحاملين للفكر السعودي، ونشر العقيدة السلفية الوهابية بين المسلمين حول العالم من شرق آسيا إلى وسط وجنوب أفريقيا وحتى أوروبا.
ورغم أن هذه السلطة الأيديولوجية المدعومة بالقوة المالية تعرّضت لضربات قوية بسبب التدقيق الذي تعرّضت له سياسات المملكة عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول وتقلُّص محفظتها المالية بفعل انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العقد الماضي، ظل الحج هو ورقة المملكة الرابحة في وقت ذوت فيه سائر المصادر الأخرى لقوتها الناعمة.
على سبيل المثال، استغلّت المملكة قدرتها على التحكم في حصة كل دولة من الحجيج من أجل إجبار العديد من الدول على اتخاذ مواقف سياسية موالية للرياض، مثل إندونيسيا، أكبر بلد في العالم الإسلامي، التي ظلّت مترددة دوما في مواجهة التبشير الديني السعودي خوفا من قيام المملكة بتقليص حصتها السنوية من الحجاج (230 ألف حاج) وهي حصة تكفي بالكاد لتلبية احتياجات أكثر من 200 مليون مسلم في البلاد ينتظر بعضهم لفترة تتعدى 20 عاما للحصول على فرصته في أداء الشعيرة المقدسة.